تركيا وإسرائيل: صراع النفوذ من أربيل إلى غزة
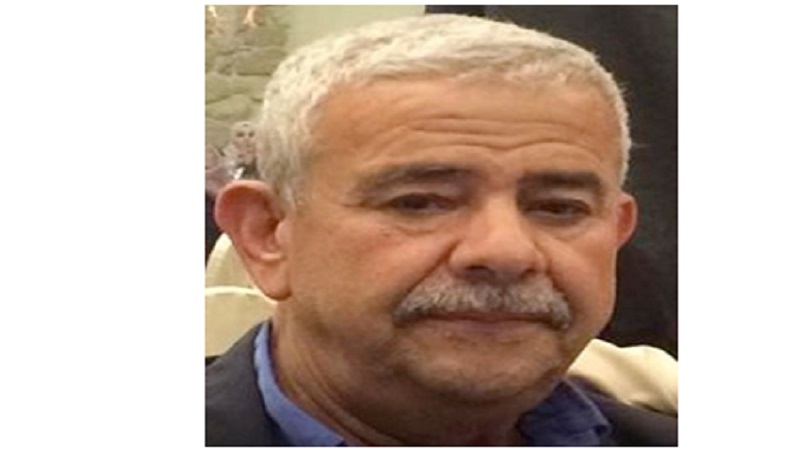
تركيا وإسرائيل: صراع النفوذ من أربيل إلى غزة
الكوفية يأتي رفض إسرائيل لمشاركة تركيا في أي قوة دولية في غزة تجسيداً لصراع جيوسياسي عميق يمتد من شمال العراق إلى القرن الأفريقي. فبينما تسعى تركيا إلى بسط نفوذها عبر مزيج من القوة العسكرية والدبلوماسية الإسلامية، تحاول إسرائيل تحجيم هذا الدور حفاظاً على هيمنتها الأمنية في المنطقة.
في هذا السياق، تعتبر إسرائيل أن غزة ساحة مركزية ورمزية في هذا التنافس على زعامة.
منذ العقد الماضي، وسّعت تركيا نطاق انتشارها ودورها الإقليمي عسكرياً في مناطق متفرقة من الشرق الأوسط وأفريقيا، في محاولة لإعادة بناء مجال نفوذها التاريخي.
في شمال العراق، تمتلك أنقرة قواعد ومراكز عمليات لملاحقة حزب العمال الكردستاني، وتبرر وجودها بأنه دفاع استباقي عن أمنها القومي.
وفي سوريا، تنتشر القوات التركية في مناطق الشمال تحت عنوان “مناطق آمنة”، لكنها عملياً تشكل منطقة نفوذ دائمة للحد من التواصل الكردي.
أما في ليبيا، فقد عززت تركيا وجودها بدعم حكومة طرابلس، وبنت قواعد في مصراتة والوطية لتوسيع حضورها في شرق المتوسط.
وفي قطر، أنشأت قاعدة عسكرية دائمة تجسد التحالف السياسي بين البلدين.
أما في الصومال، فأقامت معسكر “تيركسوم” الذي يُعد أكبر قاعدة تركية خارج البلاد لتدريب الجيش الصومالي ومراقبة الممرات البحرية فالاستراتيجية في القرن الإفريقي.
كما أن هناك بعض النفوذ في السودان من خلال علاقات التسليح واستئجار جزيرة "سواكن" في البحر الأحمر التي لم تُستخدم بعد.
بهذه الشبكة، رسخت أنقرة وجوداً جغرافياً ممتداً من البحر الأسود إلى القرن الأفريقي، مستخدمة أدوات القوة الناعمة كالمساعدات والتعليم، إلى جانب القوة الصلبة.
وعلى الجانب الموازي إسرائيل بنفوذها لا تنشر جيوشاً، لكنها تبني نفوذها عبر التكنولوجيا والاستخبارات والتحالفات الاقتصادية.
في كردستان العراق، تواجد ودعم إسرائيلي قوي من خلال محطات الموساد في أربيل، بينما توجد القوات التركية في دهوك والزاب، ما يجعل المنطقة ساحة تماس استخبارية حساسة.
وفي ليبيا، تقيم تل أبيب قنوات اتصال غير معلنة مع برقة، في حين تدعم أنقرة حكومة طرابلس المعترف بها دولياً.
أما في أفريقيا، فتركّز إسرائيل على النفوذ الاقتصادي والأمني من خلال الزراعة والتكنولوجيا والتدريب الأمني، في اثيوبيا وجنوب السودان وأوغندا، وتواجد استخباراتي في صوماليا لاند بينما تعتمد تركيا على القواعد العسكرية والمساعدات الإنسانية.
هذا التداخل في مجالات التأثير جعل كل طرف يرى الآخر منافساً لا شريكاً، رغم العلاقات التجارية بينهما.
غزة، هي الرمز المتنازع عليه، تمثل غزة لتركيا أكثر من مجرد ملف إنساني، إنها رمز سياسي وديني تستخدمه أنقرة لتأكيد حضورها في العالم الإسلامي.
أردوغان صوّرها مراراً ك"ضمير الأمة"، واحتضنت تركيا العشرات والمئات من قيادات وكوادر حركة حماس وقدّمت للحركة مشاريع تنموية ومساعدات مستمرة.
أما بالنسبة لإسرائيل، فغزة هي الخاصرة ، وجزء من أمنها الداخلي. ومن هذا المنطلق، ترى تل أبيب في أي وجود تركي هناك تهديداً مزدوجاً: من جهة أمنياً، لأنه يفتح الباب أمام اختراق استخباراتي تركي في خاصرتها مباشرةً، ومن جهة أخرى رمزياً، لأنه يمنح أنقرة موقعاً أخلاقياً وسياسياً في قلب الصراع.
وعندما طُرحت فكرة تشكيل قوة دولية لإدارة غزة بعد الحرب، سارعت إسرائيل، بدعم أمريكي ومصري وخليجي، إلى رفض أي دور تركي فيها.
حيث برر السياسيون الإسرائيليون موقفهم بأن أنقرة ليست طرفاً محايداً، فهي تدعم حركة حماس علناً وترفض تصنيفها كمنظمة إرهابية، ما يجعل مشاركتها في أي قوة أمراً غير مقبول.
أما من الناحية الأمنية، فوجود قوات تركية في غزة يعني تواجد خصم إقليمي على حدود إسرائيل مباشرة، وذلك يعني توظيف هذا الوجود في النفوذ الاستخباراتي.
أما إقليمياً، تعارض مصر والسعودية والإمارات هذا الدور بشدة، لأنهم يرون في النفوذ التركي امتداداً لمشروع “الإسلام السياسي” الذي يهدد مصالحهم.
ومن الناحية الرمزية، فإن مشاركة تركيا في أي ترتيبات تخص غزة ستُضعف السردية الإسرائيلية التي ترى نفسها الجهة الوحيدة القادرة على فرض الأمن وضبط التوازن في القطاع.
وهذا يعني أن إسرائيل ترفض تركيا لأنها دولة منافسة تحمل مشروعًا إقليمياً بديلاً عن النموذج الإسرائيلي-الأمريكي.
كما أن صراع النفوذ بين تركيا وإسرائيل يتجاوز حدود غزة ليشمل ملفات الطاقة والممرات البحرية والتحالفات الإقليمية.
في شرق المتوسط، تتنافس الدولتان على خطوط الغاز ومشاريع النقل البحري، خصوصاً مشروع خط “إيست ميد” الذي يستثني تركيا.
وفي البحر الأحمر والقرن الأفريقي، تسعى أنقرة لتوسيع وجودها عبر الصومال والسودان، بينما تعمل إسرائيل على بناء تحالفات أمنية مع دول مثل إثيوبيا وكينيا وتشاد.
وفي شمال أفريقيا، يقف الطرفان على طرفي نقيض؛ فتركيا تدعم حكومة طرابلس، بينما تميل إسرائيل إلى محور برقه.
هذه التشابكات تجعل أي تمدد تركي إضافي في غزة أو البحر المتوسط موضع قلق استراتيجي لتل أبيب، لأنها تراه جزءًا من مشروعٍ موازٍ لطموحها الإقليمي.
كما أن صدام المشاريع بين تركيا وإسرائيل لا يقتصر على تنافس المصالح، بل يعكس اختلافاً جوهرياً في الرؤية والمشروع.
فإسرائيل تمثل نموذجاً غربياً يعتمد على التفوق التكنولوجي والاستخباراتي لحماية أمنها وضمان ردع خصومها.
بينما تمثل تركيا مشروعاً يمزج بين الهوية الإسلامية والطموح القومي، وتسعى من خلاله لإعادة التموضع في مركز العالم الإسلامي والعربي.
ولهذا، ترى إسرائيل أن السماح لتركيا بلعب دور في غزة يعني فتح الباب لمشروع منافس داخل حدود نفوذها الأمني.
وبهذا نخلص إلى أن رفض إسرائيل لمشاركة تركيا في القوة الدولية يتجاوز حدود الخلاف الدبلوماسي، ليكشف عن صراعٍ أعمق على قيادة الشرق الأوسط.
تركيا تسعى لإعادة تعريف مكانتها عبر الحضور العسكري والرمزي والديني، في حين تعمل إسرائيل على تكريس تفوقها الأمني عبر التحالفات الغربية.
وغزة، مرة أخرى تعكس صدام نموذجين:
تركيا التي تريد أن تمثل “الأمة الإسلامية”، وإسرائيل التي تسعى لترسيخ “أمنها الإقليمي الأبدي”.
وهكذا، فإن الصراع الحقيقي ليس حول من يشارك في إعمار غزة، بل حول من يملك حق التحدث باسمها في ميزان القوة الجديد للمنطقة.








